مسائل منتقدة على الاحناف - مختلفة1
(1) حَدَّثنا ابنُ نُمَيْرٍ وأَبُو أُسَامَةَ عَن عُبَيْدِاللهِ بنِ عُمَرَ عن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَسَمَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ
وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا. أخرجه البخاري (4228)، ومسلم (1762).
(2) حَدَّثنا حَفْصٌ عن غِيَاثٍ عن حَجَّاجٍ عن مَكْحُولٍ: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- جَعَلَ لِلْفَارِسِ ثَلاثَةَ أَسْهُمٍ: سَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ وَسَهْمًا لَهُ. أبو داود في المراسيل (289).
(3) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنْ أُسَامَةَ بنِ زَيْدٍ عن مَكْحُولٍ قَالَ: أَسْهَمَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا. المراسيل (289).
(4) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَن أَبِي صَالِحٍ عن ابنِ عَبَّاسٍ: أنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- جَعَلَ لِلْفَارِسِ ثَلاثَةَ أَسْهُمٍ: سَهْمًا لَهُ وَسَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ. رواه أبو إسحاق بن راهويه في مسنده كما عزاه إليه الزيلعي في نصب الراية (4/ 276)، وحجاج هو ابن أرطاة، قال الحافظ في التقريب: أحد الفقهاء، صدوق كثير الخطأ والتدليس.
(5) حدَّثنَا أَبُو خَالِدٍ عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ عن صَالِحِ بنِ كَيْسَانَ: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- أَسْهَمَ يَوْمَ خَيْبَرَ لِمِائَتَي فَرَسٍ لِكُلِّ فَرَسٍ سَهْمَيْنِ. أخرجه عبدالرزاق في المصنف (5/ 186-187).
وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: سَهْمٌ لِلْفَرسِ وَسَهْمٌ لِصَاحِبِهِ.
***
ذهب جمهور العلماء إلى أن الغنيمة يقسم منها للفارس ثلاثة أسهم: سهم له، وسهمان لفرسه، وقال أبو حنيفة: للفرس سهم واحد، وقد خالفه صاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن فوافقا سائر العلماء.
قال أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن (3/ 87): "اختلف في سهم الفارس فقال أبو حنيفة: للفارس سهمان وللراجل سهم. وقال أبو يوسف ومحمد وابن أبي ليلى ومالك والثوري والليث والأوزاعي والشافعي: للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم.
وروي مثل قول أبي حنيفة عن المنذر ابن أبي حمصة عامل عمر أنه جعل للفارس سهمين وللراجل سهماً فرضيه عمر ومثله عن الحسن البصري". وراجع الهداية وشروحها: فتح القدير (5/ 492)، والعناية (5/ 493)، ونصب الراية (4/ 273).
قال في المدونة: "قلت: فكم يجب للفرس في الغنيمة؟ قال: سهمان للفرس وسهم لفارسه عند مالك فذلك ثلاثة أسهم". أحكام القرآن لابنا لعربي (2/ 409)، والمدونة (1/ 518)، وراجع مختصر خليل وشروحه: التاج والإكليل (4/ 550)، وشرح الخرشي (3/ 108)، ومواهب الجليل (3/ 367)، ومنح الجليل (3/ 193).
قال الشافعي في الأم (4/ 152، 7/ 355): "ثم يعرف عدد الفرسان والرجالة من بالغي المسلمين الذي حضروا القتال، فيضرب للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهماً، فيُسوي بين الراجل والراجل فيعطيان سهمًا سهمًا ويفضل ذو الفرس". وراجع المنهاج وشروحه: تحفة المحتاج (7/ 147)، مغني المحتاج (4/ 168)، نهاية المحتاج (6/ 149).
قال في المغني (6/ 322): "ذهب جمهور أهل العلم إلى أن للراجل سهمًا وللفارس ثلاثة أسهم. وقال أبو حنيفة: للفارس سهمان، وخالفه أصحابه فوافقوا سائر العلماء". وراجع: الفروع (6/ 226)، والإنصاف (4/ 173).
-أدلة الجمهور:
استدل الجمهور على ما ذهبوا إليه بحديث ابن عمر المخرّج في الصحيحين، ولكن الاختلاف الواقع فيه جعل الحنفية ينازعون الجمهور في الاستدلال به.
هذا الحديث رواه عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، واختلف عليه فيه، فرواه أغلب الرواة عنه بألفاظ متقاربة يُستدل بها لمذهب الجمهور، وخالف بعضهم فرواه بألفاظ يستدل بها لمذهب الحنفية.
فرواه البخاري (2863) من طريق أبي أسامة عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهمًا. والحديث بهذا اللفظ دليل للجمهور لا اختلاف فيه.
ورواه البخاري من طريق زائدة عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهمًا. قال: وفسره نافع فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم -سبق تخريجه في أول حديث بالمسألة-.
ورواه مسلم (1762)، والترمذي (1641) من طريق سليم بن أخضر عنه بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهمًا.
ورواه أحمد في مسنده (2/ 143)، ومن طريقه أبو داود (2735) عن أبي معاوية عنه بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم، سهمًا له وسهمين لفرسه. ورواه أحمد في مسنده (2/ 2) عن ابن نمير عنه بلفظ: قسم للفرس سهمين وللرجل سهمًا.
ورواه أحمد (2/ 08، 251) عن عبدالرزاق عن سفيان الثوري عنه به مثله. ورواه الدارقطني في سننه (4/ 104) من طريق النضر بن محمد عن حماد بن سلمة عنه به نحوه.
ثم خالف بعض الرواة عن عبيدالله بن عمر فرووه بألفاظ توافق مذهب أبي حنيفة، ومن ذلك:
قال الدارقطني في سننه (4/ 106): حدثنا أبو بكر النيسابوري، حدثنا أحمد بن منصور، حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة وابن نمير قالا: حدثنا عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفارس سهمين وللراجل سهماً.
قال لنا النيسابوري: هذا عندي وهم من ابن أبي شيبة أو من الرمادي؛ لأن أحمد ابن حنبل وعبدالرحمن بن بشر وغيرهما رووه عن ابن نمير خلاف هذا، ورواه ابن كرامة وغيره عن أبي أسامة خلاف هذا أيضاً". ورواية ابن بشر وابن كرامة رواهما الدارقطني (4/ 102).
قلتُ: والوهم في ذلك عندي من الرمادي أحمد بن منصور أبي بكر، ولا شك في ذلك؛ لأن الحديث في مصنف ابن أبي شيبة كرواية الجماعة المؤيدة لمذهب الجمهور كما في صدر المسألة، وهو ما يتفق مع إيراد ابن أبي شيبة لها على أبي حنيفة.
ومن الروايات المخالفة: ما رواه الدارقطني في سننه (4/ 106) قال: حدثنا أبو بكر النيسابوري، حدثنا أحمد بن منصور، حدثنا نعيم بن حماد، حدثنا ابن المبارك عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أسهم للفارس سهمين وللراجل سهمًا.
وجميع رجال الإسناد ثقات، وهو أصح ما يستدل به لمذهب الحنفية، لولا ما فيه من المخالفة لرواية الجماعة عن عبيدالله بن عمر، وكانت الجادة أن يتهم بها عبدالله ابن المبارك، ولكن لجلالته اتهم بها نعيم بن حماد الراوي عنه، كما قال أبو بكر النيسابوري: ولعل الوهم من نعيم؛ لأن ابن المبارك من أثبت الناس. [سنن الدارقطني (4/ 106)].
ورواه الدارقطني في سننه أيضاً (4/ 107) قال: حدثنا أبو بكر النيسابوري، حدثنا أحمد بن ملاعب حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم للفارس سهمين وللراجل سهمًا.
قال الدارقطني: "كذا قال وخالفه النضر بن محمد عن حماد وقد تقدم ذكره".
إذن فالمحفوظ في حديث ابن عمر هذه الألفاظ التي تؤيد مذهب الجمهور، وأما الروايات الأخرى فهي شاذة لمخالفتها ما رواه الجماعة.
وقد روى الدارقطني في سننه (4/ 106) من طرق عبدالله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر بلفظ الشك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسهم للفارس أو للفرس سهمين وللراجل سهمًا. وهي تؤيد مذهب أبي حنيفة لولا ضعف عبدالله بن عمر العمري -عبدالله العمري قال عنه أحمد: كان يزيد في الأسانيد ويخالف. وقال ابن معين: صويلح. وفي رواية: ليس به بأس. وقال ابن المديني والنسائي: ضعيف. راجع ترجمته في تهذيب الكمال (15/ 327)-. مع ما فيها من مخالفة لرواية أخيه عبيدالله فتعتبر هذه الروايات منكرة.
حديث آخر: ومما يصلح للاحتجاج به للجمهور ما رواه أحمد وأبو داود في سننه (2736) من طريق أبي عبدالرحمن المقرئ عن المسعودي عن ابن أبي عمرة قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة نفر ومعنا فرس، فأَعطى كل إنسان منا سهمًا وأعطى الفرس سهمين.
والمسعودي هو عبدالرحمن بن عبدالله بن عتبة، وثقه أحمد ويحيى بن معين وعلي ابن المديني وقال النسائي: ليس به بأس. وقال محمد بن سعد: كان ثقة كثير الحديث إلا أنه اختلط في آخر عمره ورواية المتقدمين عنه صحيحة. قال أحمد: إنما اختلط المسعودي ببغداد، ومن سمع منه في الكوفة والبصرة فسماعه جيد، وتُوفي المسعودي ببغداد سنة ستين ومائة. انظر: تهذيب الكمال (17/ 219).
والراوي عنه عبدالله بن يزيد أبو عبدالرحمن المقرئ ثقة فاضل من المتقدمين، أقرأ القرآن نيفًا وسبعين سنة، توفي بمكة سنة ثلاث عشرة ومائتين، وقد قارب المائة، أصله من البصرة أو الأهواز، وليس له ذكر في تاريخ بغداد [تهذيب الكمال (61/ 320)]. فَسِلم الحديث بذلك من علة اختلاط المسعودي وصلح بذلك للاحتجاج.
حديث آخر: روى البيهقي في دلائل النبوة (4/ 24) في باب غزوة بني قريظة بسنده عن ابن إسحاق قال: حدثني عبدالله ابن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: لم تقع القسمة ولا السهم إلا في غزوة بني قريظة، كانت الخيل يومئذ ستة وثلاثين فرسًا، ففيها أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمان الخيل، وسهمان الرجال، فعلى سننها جرتْ المقاسم، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ للفارس وفرسه ثلاثة أسهم: له سهم ولفرسه سهمان وللراجل سهمًا. قال البيهقي: "وهذا هو الصحيح المعروف بين أهل المغازي". وتعليق البيهقي في آخر الحديث لم أجده في مطبوعة الدلائل، ونقله الزيلعي في نصب الراية (4/ 277).
أضف إلى ذلك ما ذكره ابن أبي شيبة من أحاديث في صدر المسألة، وذكر الزيلعي في نصب الراية (4/ 276) أحاديث أخرى لا تنهض للاحتجاج، ومن أراد الوقوف عليها فلينظرها هناك.
-أدلة الحنفية:
استدل الحنفية بأدلة نقلية وعقلية:
أولاً: الأدلة النقلية:
1- استدل الحنفية بتلك الروايات من حديث ابن عمر التي جاءت مخالفة لأغلب روايات الحديث؛ كرواية ابن المبارك وحجاج بن منهال وعبدالله بن عمر العمري.
2- أخرج أحمد وأبو داود عن مجمع بن يعقوب بن مجمع بن يزيد الأنصاري قال: سمعت أبي يعقوب بن مجمع يذكر عنه عمه عبدالرحمن بن يزيد الأنصاري عن عمه مجمع ابن جارية الأنصاري، وكان أحد القراء الذين قرؤوا القرآن، قال: شهدنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصرفنا عنها إذا الناس يَهُزُّون الأباعر -الأباعر: جمع بعير، والمعنى يحركون ويسرعون رواحلهم. كما في عون المعبود (7/ 289)-، فقال بعض الناس لبعض: ما للناس؟ قالوا: أوحى الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجنا مع الناس نُوجِفُ، فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم واقفًا على راحلته عند كُرَاعٍ الغَمِيم، فلما اجتمع عليه الناس قرأ عليهم: (إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا) [الفتح: 1] فقال رجل: يا رسول الله أفتح هو؟ قال: (نعم، والذي نفس محمد بيده إنه لفتح)، فقسمت خيبر على أهل الحديبية، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثمانية عشر سهمًا، وكان الجيش ألفًا وخمسمائة، فيهم ثلاثمائة فارس، فأعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل سهمًا.
قال أبو داود في سننه (2738): "حديث أبي معاوية -يعني حديث ابن عمر- أصح والعمل عليه، وأرى الوهم في حديث مجمع أنه قال: ثلاثمائة فارس وكانوا مائتي فارس". وانظر: مسند أحمد (3/ 420).
ويعقوب بن مجمع ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ ابن حجر: مقبول. انظر: تهذيب الكمال (32/ 363)، والثقات (7/ 642)، والتقريب (7832).
وذكر الزيلعي أحاديث أخرى لا تخلو أسانيدها من مقال. راجع: نصب الراية (4/ 278).
وبالنظر في أحاديث الباب مجتمعة نجد أنها متعارضة، فذهب الجمهور إلى ترجيح الروايات التي أثبتت وجوب ثلاثة أسهم للفارس: سهمين لفرسه وسهم له، أما الحنفية فجمعوا بينها؛ لأن الجمع أَوْلَى من إبطال أحدها، فقالوا: تحمل الروايات المثبتة للثلاثة الأسهم على التنفيل، كما نفل النبي صلى الله عليه وسلم سلمة بن الأكوع سهم الفارس مع سهم الراجل، وتحمل روايات السهمين على الوجوب -مسلم (4779)-.
ثانيًا: الأدلة العقلية:
إن استحقاق الغنيمة يكون بالغناء في القتال والفارس يقاتل بنفسه وبفرسه، والراجل يقاتل بنفسه، فكان النظر أن يُعطى الفارس ضعف الراجل. راجع: الهداية (5/ 495).
ويحكى عن أبي حنيفة أنه قال: لا أجعل سهم الفرس أفضل من سهم الرجل المسلم [شرح السير الكبير (3/ 885)]؛ لأن الثابت عند أبي حنيفة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أسهم للفرس سهمًا ولصاحبه سهمًا؛ ولذلك فإن أبا حنيفة سَاوَى بين الرجل والفرس في الاستحقاق، لثبوت السنة به عنده، ولم يجوز التفضيل في الاستحقاق لعدم ثبوته عنده.
ومن جهة النظر فإن غناء الرجل في القتال أظهر منه في الفرس، ألا ترى أن الفرس لا يقاتل بدون الرجل، والرجل يقاتل بدون الفرس، فلا وجه بذلك لتفضيل الفرس. ولو فُهم هذا الكلام في ضوء ما ثبت عند أبي حنيفة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما شنع عليه أحد بكلامه هذا.
وقال السرخسي: "وإذا أصاب المسلمون الغنائم فأحرزها وأرادوا قسمتها فعلى قول أبي حنيفة رضي الله عنه: يُعطى الفارس سهمين، سهمًا له وسهمًا لفرسه، والراجل سهمًا. وقال: لا أجعل سهم الفرس أفضل من سهم الرجل المسلم، وهو قول أهل العراق من أهل الكوفة والبصرة. وعلى قول أبي يوسف ومحمد -رحمهما الله- للفارس ثلاثة أسهم: سهم له وسهمان لفرسه. وهو قول أهل الحجاز وأهل الشام.
قال محمد بن الحسن: وليس في هذا تفضيل البهيمة على الآمدي، فإن السهمين لا يعطيان للفرس، وإنما يعطيان للفارس، فيكون في هذا تفضيل الفارس على الراجل، وذلك ثابت بالإجماع، ثم هو يستحق أحد السهمين بالتزام مؤنة فرسه والقيام بتعاهده والسهم الآخر لقتاله على فرسه، والسهم الثالث لقتاله ببدنه. وقال: أرجح هذا القول؛ لأنه اجتمع عليه فريقان". انظر: شرح السير الكبير (3/ 885)، وراجع: المبسوط (10/ 41)، وتبيين الحقائق (3/ 254)، والبحر الرائق (5/ 96).
وفي نهاية المطاف نجد أن أدلة الجمهور أكثر مخرجًا وأصح إسنادًا، فمذهبهم أرجح؛ بل أصوب من مذهب أبي حنيفة، ولعل عذر أبي حنيفة أنه لم تبلغه أحاديث الثلاثة الأسهم من وجه معتبر عنده، فلما بلغت صاحبيه رجعا عن مذهبه وقالا بمذهب الجمهور.
ثانياً: مَسْأَلَةُ السَّفَرِ بِالْقُرْآنِ إِلَى الْعَدُوِّ
(1) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ العَدُوِّ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ. أخرجه البخاري (2990)، ومسلم (4946).
وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: لا بَاْسَ بِذَلِكَ.
***
اتفق الفقهاء أن لا يسافر بالمصحف إلى أرض العدو إذا خيف وقوعه في أيديهم؛ لما في ذلك من تعريضه لاستحقاقهم به وهو حرام، فما أدرى إلى ذلك فهو حرام.
واختلفوا في حالة الأمن من ذلك، فذهب الحنفية والشافعية إلى جوازه، وذهب المالكية والحنابلة والظاهرية إلى المنع من مطلقًا.
وقد نصَّ الحنفية على أن الأمن يكون في حالتين:
الأولى: أن يسافر بالمصحف في عسكر عظيم، وأقله عند الإمام أبي حنيفة أربعة آلاف، واختار الكمال بن الهمام أن أقله اثنا عشر ألفًا.
الثانية: أن يسافر المصحف إليهم بأمان إذا كانوا قومًا يوفون بالعهد.
ومذهب الحنفية على هذا التفصيل يتفق تمامًا مع حديث النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو؛ إذ نصَّ في آخره على علة النهي وهي مخافة أن يناله العدو، فإذا زال ذلك الخوف جاز عندئذ السفر به إلى أيِّ مكان؛ فالحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، نفيًا وإثباتًا، والعلة في هذا الحديث منصوصة وهي أعلى أنواع العلل.
ومذهب الحنفية يعتبر في هذه المسألة أصح المذاهب وأقربها إلى تحقيق مصالح العباد التي راعتها الشريعة، فلو لم يجوِّزْ الحنفية ذلك ماذا كان يفعل المسلمون اليوم الذين يعيشون في ديار غير المسلمين لأيِّ سببٍ من الأسباب، ماذا يفعلون وقد حرم المالكية والحنابلة والظاهرية أخذهم لكتاب ربهم، وهكذا نجد أن أبا حنيفة سبق عصره بفكره وفطنته، وبمعرفته لعلل الأحكام ومراعاة المقاصد الشرعية.
قال السرخسي: "ولا بأس بإدخال المصاحف في أرض العدو لقراءة القرآن في مثل هذا العسكر العظيم، ولا يستحب له ذلك إذا كان يخرج في سرية؛ لأن الغازي ربما يحتاج إلى القرءة من المصحف إذا كان لا يحسن القراءة عن ظهر قلبه، أو يتبرك بحمل المصحف ويستنصر به؛ فالقرآن حبل الله المتين من اعتصم به نجا، إلا أنه منهي عن تعريض المصحف لاستخفاف العدو به؛ ولهذا لو اشتراه ذمي أجبر على بيعه، والظاهر أنه في العسكر العظيم يأمن هذا لقوتهم، وفي السرية ربما يبتلي به لقلة عددهم، فمن هذا الوجه يقع الفرق. والذي روي أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى أن يسافر بالقرآن في أرض العدو. تأويل هذا أن يكون سفره مع جريدة خيل لا شوكة لهم، هكذا ذكره محمد.
وذكر الطحاوي أن هذا النهي كان في ذلك الوقت؛ لأن المصاحف لم تكثر في أيدي المسلمين، وكان لا يؤمن إذا وقعت المصاحف في أرض العدو أن يفوت شيء من القرآن من أيدي المسلمين، ويؤمن إذا وقعت من مثله في زماننا لكثرة المصاحف وكثرة القراء.
قال الطحاوي: ولو وقع مصحف في يدهم لم يستخفوا به؛ لأنهم وإن كانوا لا يقرون بأنه كلام الله، فهم يقرون بأنه أفصح الكلام بأوجز العبارات وأبلغ المعاني، فلا يستخفون به كما لا يستخفون بسائر الكتب، لكن ما ذكره محمد أصح، فإنهم يفعلون ذلك مغايظة للمسلمين". انظر: شرح سير الكبير (1/ 205)، وراجع: المبسوط (10/ 30).
وقال في الهداية: "(ولا بأس بإخراج النساء والمصاحف مع المسلمين إذا كانوا عسكرًا عظيمًا يؤمن عليه) لأن الغالب هو السلامة والغالب الكمتحقق (ويكره إخراج ذلك في سرية لا يؤمن عليها) لأن فيه تعريضهن على الضياع والفضيحة وتعريض المصاحف على الاستخفاف، فإنهم يستحقون بها مغايظة للمسلمين، وهو التأويل الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو. ولو دخل مسلم إليهم بأمان لا بأس بأن يحمل معه المصحف إذا كانوا قومًا يفون بالعهد؛ لأنا لظاهر عدم التعرض". راجع الهداية وشروحها: فتح القدير (5/ 450)، والعناية (5/ 450)، ونصب الراية (4/ 232)، وراجع: بدائع الصنائع (7/ 102)، والبحر الرائق (5/ 83).
وقال الكمال بن الهمام في فتح القدير (5/ 450): "قال أبو حنيفة: أقل السرية أربعمائة وأقل العسكر أربعة آلاف. والذي يؤمن عليه في توغله في دار الحرب ليس إلا العسكر العظيم، وينبغي كونه اثنى عشر ألفًا، لما روى أنه عليه الصلاة والسلام قال: (لن يغلب اثنا عشر ألفًا من قلة) -رواه أبو داود (2613) من حديث ابن عباس مرفوعًا بلفظ: (خير الصحابة أربعة، وخير السرايا أربعمائة، وخير الجيوش أربعة آلاف، ولن يغلب اثنا عشر ألفًا من قلة). وقال: والصحيح أنه مرسل. ورواه في المراسيل (1/ 238) عن الزهري به مرسلًا. ورواه ابن ماجه (2934) من حديث أنس بن مالك مرفوعًا-. وهو أكثر ما روي فيه هذا باعتباره أحوط".
وقال أبو جعفر الطحاوي في مشكل الآثار (2/ 162): "وقد اختلف أهل العلم في السفر به إلى أرض العدو فذهب بعضهم إلى إباحة ذلك؛ منهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد، كما حدثنا محمد ابن العباس قال: حدثنا علي بن معبد عن محمد بن الحسن عن يعقوب عن أبي حنيفة ولم يحك خلافًا بينهم، وذهب بعضهم إلى كراهة ذلك، وقد روي هذا القول عن مالك بن أنس، وذهب محمد بن الحسن بآخره في سيره الكبير إلى أنه كان مأمونًا عليه من العدو فلا بأس بالسفر به إلى أرضهم، وإن كان مخوفًا عليه منهم فلا ينبغي السفر به إلى أرضهم، ولم يحك هناك خلافًا في ذلك بينه وبين أحد من أصحابه، فاحتمل أن يكون ما في الرواية الأولى التي رويناها من إباحة السفر به إلى أرض العدو عند الأمان عليه من العدو، وهذا القول أحسن ما قيل في هذا الباب والله تعالى نسأله التوفيق".
ولعل ما نقله الطحاوي في صدر كلامه مذهبًا لأبي حنيفة هو ما دعا ابن أبي شيبة لإيراد حديث الباب عليه، وإلا فمذهب أبي حنيفة على التفصيل المذكور ليس فيه مخالفة للحديث كما سبق تقريره.
قال ابن عبدالبر في التمهيد (15/ 254): "أجمع الفقهاء أن لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو في السرايا والعسكر الصغير المخوف عليه، واختلفوا في جواز ذلك في العسكر الكبير المأمون عليه. قال مالك: لا يسافر إلى أرض العدو. ولم يفرق بين الصغير والكبير، وقال أبو حنيفة: يكره أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، إلا في العسكر العظيم فإنه لا بأس بذلك". وراجع: المنتقى شرح الموطأ (3/ 153)، وشرح مختصر خليل (3/ 92).
قال النووي في المجموع شرح المهذب (2/ 77): "اتفقوا على أنه لا يجوز المسافرة بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خِيفَ وقوعه بين أيديهم لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو). واتفقوا على أنه يجوز أن يكتب إليهم الآية والآيتين وشبههما في أثناء كتاب لحديث أبي سفيان رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل عظيم الروم كتابًا فيه: (يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ) [آل عمران: 64]". وراجع: حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 41).
قال ابن قدامة في المغني (1/ 97): "ولا يجوز المسافرة بالمصحف إلى دار الحرب". وراجع: كشاف القناع (3/ 62)، ومطالب أولي النهي (1/ 155).
قال ابن حزم في المحلى بالآثار (5/ 418): "ولا يحل السفر بالمصحف إلى أرض الحرب لا في عسكر ولا في غير عسكر. وقال مالك: إن كان عسكر مأمون فلا بأس به. قال أبو محمد: وهذا خطأ وقد يهزم العسكر المأمون، ولا يجوز أن يعترض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخص بلا نص".
ثالثًا: مَسْأَلَةُ الْعَدْلِ بَيْنَ الأَوْلَادِ
(1) حَدَّثنَا ابنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَن حُمَيْدِ بنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ أَبَاهُ نَحَلَهُ غُلامًا، وَأَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- لِيُشْهِدَهُ فَقَالَ: (أَكُلَّ وَلَدَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟). قَالَ: لا. قَالَ: (فَارْدُدْهُ). أخرجه البخاري (2586)، ومسلم (4262).
(2) حَدَّثنَا عَبَّادٌ عَن حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةٌ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لا أَرْضَي حَتَّى تُشْهِدَ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-. قَالَ: فَأَتَى النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ عَطِيَّةً فَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ. قَالَ: (أَعْطَيْتَ كُلَّ وَلَدِك مِثْلَ هَذَا؟). قَالَ: لا. قَالَ: (فَاتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ). أخرجه البخاري (2587)، ومسلم (4268).
(3) حَدَّثنَا ابنُ مُسْهِرٍ عَنْ أَبِي حَيَّانَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بنِ بَشِيرٍ عَن النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ: (لا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ). أخرجه البخاري (2650)، ومسلم (4269).
وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: لا بَأْسَ بِهِ.
***
اختلف العلماء في وجوب التسوية بين الأولاد في العطية؛ فذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن التسوية بينهم في العطايا مستحبة، وليست واجبة. وذهب الحنابلة والظاهرية وهو قول ابن المبارك وطاوي إلى وجوب التسوية بين الأولاد في الهبة. فإن خص بعضهم بعطية أو فاضل بينهم فيها أثم، ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين؛ إما رد ما فضل به البعض، وإما إتمام نصيب الآخر.
قال أبو جعفر الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 84، 88): "فذهب قوم إلى أن الرجل إذا نحل بعض بنيه دون بعض أن ذلك باطل. واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وقالوا: قد كان النعمان في وقت ما نحله أبوه صغيرًا فكان أبوه قابضًا له لصغره عن القبض لنفسه. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (اردده) بعدما كان في حكم ما قبض، دلَّ أن النحلى من الوالد لبعض ولده دون بعض لا يملكه المنحول ولا ينعقد له عليه هبة.
وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: ينبغي للرجل أن يسوي بين ولده في العطية ليستووا في البر، ولا يفضل بعضهم على بعض فيوقع ذلك له الوحشة في قلوب المفضولين منهم، فإن نحل بعضهم شيئًا دون بعض وقبضه المنحول لنفسه إن كان كبيرًا، أو قبضه له أبوه من نفسه إن كان صغيرًا لإعلامه إياه والإشهاد به فهو جائز، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين".
قال ابن قدامة في المغني (5/ 387): "وإذا فاضل بين ولده في العطية أمر برده كأمر النبي صلى الله عليه وسلم وجملة ذلك: أنه يجب على الإنسان التسوية بين أولاده في العطية، وإذا لم يختص أحدهم بمعنى يبيح التفضيل، فإن خص بعضهم بعطيته، أو فاضل بينهم فيها أَثِمَ ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين: إما رد ما فضل به البعض، وإما إتمام نصيب الآخر. قال طاوس: لا يجوز ذلك ولا رغيف محترق. وبه قال ابن المبارك ورُوي معناه عن مجاهد وعروة، وكان الحسن يكرهه، ويجيزه في القضاء، وقال مالك والليث والثوري والشافعي وأصحاب الرأي: ذلك جائز، ورُوي معنى ذلك عن شريح وجابر بن زيد والحسن بن صالح". وراجع: إعلام الموقعين (4/ 255).
وقال أبو محمد بن حزم في المحلى بالآثار (8/ 59): "ولا يحل لأحد أن يهب، ولا أن يتصدق على أحد من ولده حتى يطعى أو يتصدق على كل واحد منهم بمثل ذلك. ولا يحل أن يفضل ذكرًا على أنثى ولا أنثى على ذكر، فإن فعل فهو مفسوخ مردود أبدًا ولا بد. وإنما هذا في التطوع وأما في النفقات الواجبات فلا، وكذلك الكسوة الواجبة. لكن ينفق على كل امرئ منهم بحسب حاجته ويتفق على الفقير منهم دون الغني".
-أدلة الجمهور:
استدل الجمهور على أن التسوية بين الأولاد في العطية مستحبة بأدلة؛ منها:
1- حديث النعمان بن بشير الذي أورده ابن أبي شيبة على أبي حنيفة، وهذا الحديث قد تنازعه الفريقان؛ فالجمهور استدل به على الاستحباب من جهة، واستدل به الآخرون على الوجوب من جهة أخرى.
فأما الجمهور فاستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم في إحدى روايات الحديث -مسلم (4272)-: (فأشهد على هذا غيري). فدلَّ على أن فعل والد النعمان لم يكن حرامًا أو باطلًا، وإنما أمره بالرد لما يستحب من التسوية بين الأولاد.
قال النووي في شرح مسلم (11/ 66، 67): "فإن قيل قاله تهديدًا. قلنا: الأصل في كلام الشارع غير هذا. ويحتمل عند إطلاقه صيغة أفعل على الوجوب أو الندب، فإن تعذر ذلك فعلى الإباحة.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: (لا أشهد على جور). فليس فيه أنه حرام لأن الجور هو الميل عن الاستواء والاعتدال، وكل ما خرج عن الاعتدال فهو جور، سواء كان حرامًا أو مكروهًا، وقد وضح بما قدمناه أن قوله صلى الله عليه وسلم: (أشهد على هذا غيري). يدل على أنه ليس بحرام، فيجب تأويل الجور على أنه مكروه كراهة تنزيه.
وفي هذا الحديث أن هبة بعض الأولاد دون بعض صحيحة، وأنه إن لم يهب الباقين مثل هذا استحب رد الأول، قال أصحابنا: يستحب أن يهب الباقين مثل الأول، فإن لم يفعل استحب رد الأول ولا يجب".
وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 85) -في قوله صلى الله عليه وسلم: (أشهد على هذا غيري)-: "هذا دليل على أن الملك ثابت؛ لأنه لو لم يصح لا يصح قوله، ولا يدل على فساد العقد الذي كان عقده النعمان؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يتوقى الشهادة على ماله أن يشهد عليه. فيكون قوله: (أشهد على هذا غيري). أي: إني أنا الإمام والإمام ليس مِنْ شأنه أن يشهد، وإنما من شأنه أن يحكم وفي هذا دليل على صحة العقد". وراجع: المنهاج وشروحه: مغني المحتاج (3/ 567)، تحفة المحتاج (6/ 307)، ونهاية المحتاج (5/ 415).
وأما قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: (فاردده). وفي رواية: (فارجعه). فقد استدل به الشافعي على جواز إعطاء الرجل بعض بنيه، فقال وهو يذكر ما يدل عليه الحديث: "ومنها أن إعطاءه بعضهم جائز، ولولا ذلك لما قال صلى الله عليه وسلم: (فارجعه). فلو كان لا يجوز كان يقال: إعطاؤك إياه وتركه سواء؛ لأنه غير جائز، فهو على أصل ملكك الأول، أشبه من أن يقال: ارجعه". انظر: اختلاف الحديث مع الأم (8/ 630)، وراجع: مختصر المزني (8/ 34).
ونُقِلَ عن مالك في قوله صلى الله عليه وسلم (فارجعه): أن ذلك فيما أرى لم يكن له مال غيره.
قال أبو الوليد الباجي في المنتقى شرح الموطأ (6/ 92): "وعندي أنه إذا أعطى البعض على سبيل الإيثار أنه مكروه، وإنما يجوز ذلك ويعرى من الكراهية إذا أعطى البعض لوجه ما من جهة يختص بها أحدهم كغرامة تلزمه، أو خير يظهر منه فيخص بذلك خيرهم على مثله، والله أعلم".
2- واستدل الجمهور بتفضيل الصحابة بعض أولادهم على بعض في العطايا.
ومن ذلك ما روي عن عائشة أنها قالت: إن أبا بكر الصديق نحلها جداد -الِدَاد بالفتح والكسر: صِرَام النخل، وهو قطع ثمرتها. راجع: النهاية (1/ 244)- عشرين وسقًا من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنية ما من أحد من الناس أحب إليَّ غِنًا منك، ولا أعز -أعز: أي أشد وأشق عليّ فقرًا- الناس عليَّ فقرًا من بعدي منك، وإني كنت نحلتك جداد عشرين وسقًا، فلو كنت جددتيه وأحرزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخوك وأختاك، فاقتسموه على كتاب الله. فقالت عائشة: والله يا أبت لو كان كذا وكذا لتركته، إنما هي أسماء فمن الأخرى. قال: ذو بطن بنت خارجة أراها جارية. أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 88).
ومن ذلك ما روي عن عمر بن الخطاب أنه فضل ابنه عاصمًا بشيء من العطية على غيره من أولاده. ذكره الشافعي في اختلاف الحديث (8/ 630).
ومن ذلك أن عبدالرحمن بن عوف فضل بني أم كلثوم بنحل قسمه بين ولده. رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 88).
فهؤلاء الصحابة فضلوا بعض أولادهم على بعض بالعطية، ورأوا ذلك جائزًا، ولم ينكر عليهم أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يجوز لأحد أن يحمل فعل هؤلاء على خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان قوله صلى الله عليه وسلم على الاستحباب.
3- استدل الجمهور أيضًا بالإجماع على جواز هبة المرء لماله للغريب، فإن أعطاه بعض ولده كان جائزًا أيضًا. انظر: النكت الطريفة (ص 22).
- أدلة الحنابلة والظاهرية:
تمسك القائلون بوجوب التسوية بين الأولاد في العطية بحديث النعمان أيضًا.
قال ابن قدامة في المغني (5/ 387): "وهو دليل على التحريم؛ لأنه سماء جورًا وأمر برده، وامتنع من الشهادة عليه والجور حرام، والأمر يقتضي الوجوب؛ ولأن تفضيل بعضهم يورث بينهم العداوة والبغضاء وقطيعة الرحم، فمنع منه كتزويج المرأة على عمتها أو خالتها.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (فأشهد على هذا غيري) ليس بأمر؛ لأن أدنى أحوال الأمر الاستحباب والندب، ولا خلاف في كراهة هذا، وكيف يجوز أن يأمره بتأكيده مع أمره برده، وتسميته إياه جورًا، وحمل الحديث على هذا حمل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم على التناقض والتضاد، ولو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإشهاد غيره لامتثل بشير أمره ولم يرد، وإنما هذا تهديد له على هذا فيفيد ما أفاده النهي عن إتمامه. والله أعلم". وراجع: إعلام الموقعين (4/ 255).
بعد هذا البيان لمذاهب العلماء في المسألة وأدلتهم، يتضح أن جمهور أهل العلم قد اتفق مع الحنفية فيما ذهبوا إليه وعولوا عليه، وأن السبب في خلاف العلماء في المسألة يرجع إلى تباين اجتهاداتهم فيما يدل عليه حديث النعمان، وما كان هذا شأنه لا يقال فيه إن أحد الفريقينِ قد خالف الحديث؛ ومن ثَمَّ فلا وجه لاتهام ابن أبي شيبة لأبي حنيفة بمخالفة الحديث في هذه المسألة.
رابعًا: مَسْأَلَةُ الْعِتْقِ مَا فَوْقَ الثُّلُثِ
(1) حَدَّثنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ: أَنَّ رَجُلًا كَانَ لَهُ سِتَّةُ أَعْبُدٍ فَأَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مضوْتِهِ، فَأَقْرَعَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً. أخرجه مسلم (4425).
(2) حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ المُخْتَارِ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- نَحْوَهُ أَوْ مِثْلَهُ. أخرجه النسائي في السنن الكبرى (4979).
وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: لَيْسَ هَذَا بِشَيءٍ وَلا يَرَى فِيهِ قُرْعَةً.
***
ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن من أعتق في مرض موته عبيدًا أو أوصى بعتقهم، ولم يجز الورثة ذلك، ولم يتسع الثلث لعتقهم أقرع بينهم وأُعتق منهم ما يخرج من الثلث، وذهب الحنفية إلى أن يعتق منهم ثلثهم، ويسعون فيما بقي من قيمتهم.
قال أبو جعفر الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 382): "تكلم الناس فيمن أعتق ستة أعبد له عند موته، لا مال له غيرهم، فأبى الورثة أن يجيزوا، فقال قوم: يعتق منهم ثلثهم، ويسعون فيما بقي من قيمتهم، وممن قال ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى. وقال آخرون: يعتق منهم ثلثهم، ويكون ما بقي منهم رقيقًا لورثة المعتق. وقال آخرون: يقرع بينهم فيعتق منهم من قرع من الثلث، ورق من بقي". وراجع: مشكل الآثار (1/ 208)، وأحكام القرآن للجصاص (2/ 21)، والمبسوط (7/ 75).
قال في المدونة (4/ 410)، (2/ 398): "قلت: أرأيت لو أن رجلًا أعتق عبيدًا له في مرضه لا يحملهم الثلث؟ قال: قال مالك: يقرع بينهم. وقال: وليست القرعة عند مالك إلا في الذي يعتق في وصيته". وراجع: المنتقى شرح الموطأ (6/ 264)، وأحكام القرآن لابن العربي (4/ 30).
قال الشافعي في الأم (4/ 99): "إذا أعتق رقيقًا له لا مال له غيرهم في مرضه ثم مات قبل أن تحدث له صحة، فإن كان عتقه في كلمة واحدة مثل أن يقول: إنهم أحرار، أو يقول: رقيقي أو كل مملوك لي حر، أقرع بينهم فأعتق ثلثه وأرق الثلثان". وانظر: أحكام القرآن (2/ 157)، وراجع المنهاج وشروحه: مغني المحتاج (6/ 461)، ونهاية المحتاج (8/ 394)، وتحفة المحتاج (10/ 369).
قال ابن قدامة في المغني (10/ 297): "فمتى أعتق ثلاثة أعبد متساوين في القيمة، هم جميع ماله، دفعة واحدة، أو دبَّرهم أو وصَّى بعتقهم، أو دبَّر بعضهم ووصى بعتق باقيهم، ولم يجز الورثة أكثر من الثلث، أقرع بينهم بسهم حرية وسهمي رق، فمن خرج له سهم الحرية عتق ورق صاحباه. وبهذا قال عمر بن عبدالعزيز وأبا بن عثمان، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وداود، وابن جرير. وقال أبو حنيفة: يعتق من كل واحد ثلثه ويستسعى في باقيه. وروي نحو هذا عن سعيد بن المسيب، وشُريح، والشعبي، والنخعي، وقتادة، وحماد؛ لأنهم تساووا في سبب الاستحقاق، فيتساوون، في الاستحقاق، كما لو كان يملك ثلثهم وحده وهو ثلث ماله، أو كما لو وصَّى بكل واحد منهم لرجل.
وأنكر أصحاب أبي حنيفة القرعة وقالوا: هي من القمار وحكم الجاهلية، ولعلهم يردون الخبر الوارد في هذه المسألة لمخالفته قياس الأصول، وذكر الحديث لحماد فقال: هذا قول الشيخ -يعني إبليس- فقال له محمد بن ذكوان: وضع القلم عن ثلاثة؛ أحدهم المجنون حتى يفيق -يعني إنك مجنون- فقال له حماد: ما دعاك إلى هذا؟ فقال له محمد: وأنت فما دعاك إلى هذا؟ وهذا قليل في جواب حماد، وكان حريًّا أن يستتاب عن هذا، فإن تاب وإلا ضربت عنقه".
ولقد تجاوز ابن قدامة حد الاعتدال في رده على حماد، إذ حكم بردته فإن تاب وإلا قطعت عنقه، فلم يقل أحد من علماء الإسلام بكفر من رد حديثًا بتأويل، وإنما قال حماد هذا؛ لأنه لا يعده حديثًا. وهذا الكلام يشبه ما قاله ابن أبي ذئب في الإمام مالك.
-أدلة الحنفية:
ذهب الحنفية إلى أن القرعة عمومًا كان يعمل بها في بدء الإسلام ثم نسخت فلا يثبت بها أحكام شرعية، وإنما تستعمل فيما يسع تركها وفيما له أن يمضيه بغيرها تطييبًا للقلوب، وقد أطال الطحاوي في تقرير ذلك، ويتخلص كلامه في عدة أمور:
1- أن بعض الأحكام في بدء الإسلام كان يُعمل فيها بالقرعة ثم نسخت، ومثَّل لذلك: بما رُوي عن زيد بن أرقم قال: كنتُ جالسًا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من اليمن فقال: إن ثلاثة من أهل اليمن أتوا عليًّا يختصمون إليه في ولد، وقد وقعوا على امرأة في طهر واحد، فقال لاثنين منهما: طيبا بالولد لهذا. فغلبا، فقال: أنتم شركاء متشاكسون إني مقرع بينكم، فمن قُرِعَ فله الولد وعليه لصاحبيه ثلاث الدية. فأرقع بينهم فجعل لمن قرع. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أضراسه أو نواجذه. رواه أبو داود (2271)، والنسائي (3502).
ثم نسخ ذلك الحكم -على حد زعم الطحاوي- بما روي عن سماك عن مولى لبني مخزومة قال: وقع رجلان على جارية فعلقت الجارية فلم يدر من أيهما هو، فأتيا عمر يختصمان في الولد، فقال عمر: ما أدري كيف أقضي في هذا. فأتيا عليًّا فقال: هو بينكما يرضكما وترثانه، وهو للباقي منكما. أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 164)، والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 268) من طريق علي بن ظبيان عن عليٍّ دون ذكر عمر، عقب ذكره لطرق قضاء عليٍّ بالقرعة في هذه المسألة، وقال: "ورُوي عن عليٍّ قضاء آخر في هذه القصة". فذكره ولم يقل إن هذا نسخ ذاك، كما ادعى الطحاوي أن القضاء بالقر عة في تلك القصة منسوخ باتفاق المخالفين.
قال الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 382): "فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عليٍّ رضي الله عنه ما حكم به في القرعة في دعوى النفر الولد، فدلَّ ذلك أن الحكم حينئذ كان كذلك، ثم نسخ بعد باتفاقنا واتفاق هذا المخالف لنا، ودلَّ على نسخه ما قد رويناه من حكم عليٍّ في مثل هذا بأن جعل الولد بين الدعيين جميعًا يرثهما ويرثانه".
وما ادعاه الطحاوي من النسخ لا يسلم له، فلعله من باب تغير الاجتهاد، وما كان كذلك لا يسمى نسخًا، كما أن الاتفاق الذي حكاه ليس ثابتًا، بدليل ما قاله البيهقي عقب روايته للأحاديث السابقة؛ حيث اعتبره قضاء آخر لعليٍّ في هذه القصة.
2- أن العمل بالقرعة نُسخ بنسخ الربا؛ إذ رُدَّتْ الأشياء إلى المقادير المعلومة التي فيها التعديل الذي لا زيادة فيه ولا نقصان.
3- أن القرعة إنما تستعمل فيما يسع تركها، وفيما له أن يمضيه بغيرها تطييبًا للقلوب ومن ذلك ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. أخرجه البخاري (2632).
يقول الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 383): "أجمع المسلمون أن للرجل أن يسافر إلى حيث أحب وإن طال سفره وليس معه أحد من نسائه، وأن حكم القسم يرتفع عنه بسفره، فلما كان ذلك كذلك كانت قرعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين نسائه في وقت احتياجه إلى الخروج بإحداهن لتطيب نفس من لا يخرج بها منهن، وليعلم أنه لم يحاب التي خرج بها عليهن؛ لأنه لما كان له أن يخرج ويخلفهن جميعًا، كان له أن يخرج ويخلف من شاء منهم.
فثبت بما ذكرناه أن القرعة إنما تستعمل فيما يسع تركها، وفيما له أن يمضيه بغيرها فكذلك نقول: كل قرعة تكون مثل هذا فهي حسنة، وكل قر عة يراد بها وجوب حكم وقطع حقوق متقدمة فهي غير مستعملة".
4- أن مذهب الحنفية أشبه بالأصول من جهة تغليب العتق ووجوب السعاية؛ فقد رُوي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أعتق شقصًا له في عبد أعتق كله إن كان له مال، وإلا يستسع غير مشقوق عليه). البخاري (2544، ومسلم (3846).
يقول الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 384): "فبيَّن رسول الله صلى الله عليه وسلم العلة التي لها عتق نصيب صاحبه، فدلَّ ذلك أن العتاق متى وقع في بعض العبد انتشر في كله، وقد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم في العبد بين اثنين إذا أعتقه أحدهما ولا ماله له، يُحكم عليه فيه بالضمان بالسعاية على العبد في نصيب الذي لم يعتق، فثبت بذلك أن حكم هؤلاء العبيد في المرض كذلك، وأنه لما استحال أن يجب على غيرهم ضمان ما جاوز الثلث الذي للميت أن يوصى به، ويُمَلِّكَه في مرضه من أحَبَّ من قيمتهم، وجب عليه السعاية في ذلك للورثة".
-أدلة الجمهور:
استدل الجمهور بأحاديث المسألة مع نفيهم لما ادعاه الحنفية من نسخ العمل بالقرعة في الأحكام، وقد أفرد الشافعي كتابًا في الأم سماه كتاب القرعة، أوضح فيه المعنى الذي من أجله شُرعت القرعة، وهو الحكم بين قوم مستوين في الحجة، مستدلًّا على ذلك بما جاء في كتاب الله عز وجل في قصة المقترعين على كفالة مريم عليها السلام والمقارعي يونس عليه السلام.
ثم قال الشافعي في الأم (8/ 3): "وقرعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل موضع أقرع فيه في مثل معنى الذين اقترعوا على كفالة مريم سواء لا يخالفه، وذلك أنه أقرع بين مماليك أعتقوا معًا؛ فجعل العتق تامًّا لثلثهم، وأسقط عن ثلثيهم بالقرعة، وذلك أن المعتِق في مرضه أعتق ماله ومال غيره، فجاز عتقه في ماله ولم يجز في مال غيره، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم العتق في ثلثه ولم يبغضه كما يجمع القسم بين أهل المواريث ولا يبغض عليهم، وكذلك كان إقراعه لنسائه أن يقسم لكل واحدة منهن في الحضر فلما كان السفر كان منزلة يضيق فيها الخروج بكلهن، فأقرع بينهن، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه وسقط حق غيرها في غيبته بها، فإذا حضر عاد للقسم لغيرها، ولم يحسب عليها أيام سفرها، وكذلك قسم خيبر فكان أربعة أخماسها لمن حضر، ثم أقرع فأيهم خرج سهمه على جزء مجتمع كان له بكماله وانقطع منه حق غيره وانقطع حقه عن غيره".
وثمة موضع آخر قضى فيه النبي بالقرعة، رواه أبو داود (3586) عن أم سلمة قالت: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان يختصمان في مواريث لهما لم تكن لهما بينة إلا دعواهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليَّ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذ منه شيئًا، فإنما أقطع له قطعة من النار). فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما: حقي لك. فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: (أما إذا فعلتما ما فعلتما فاقتسما وتوخيا الحق، ثم استهما وتحالَّا).
وروى أبو داود أيضًا (3618) عن أبي هريرة أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس لواحد منهما بينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (استهما على اليمين ما كان أحبا ذلك أو كرها).
وقد أطال ابن قدامة في الرد على الحنفية فيما قالوه من مخالفة حديث الباب لقياس الأصول، والطحاوي وإن لم يصرح بذلك فقد أشار في كلامه إلى أن قول الحنفية موافق للقياس، وهو ما يفهم منه أن حديث الباب مخالف للقياس، وهو ما اجتهد الحنفية في نفيه نظريًّا في منهجهم، إلا أن البحث في الفروع يبين خلاف ذلك، كما في هذه المسألة، وفي مسألة الصلاة في أعطان الإبل.
وقد بين ابن قدامة أن حديث الباب لا يخالف القياس، ثم قال في المغني (10/ 297): "وإن سلمنا مخالفته قياس الأصول، فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب الاتباع سواء وافق القياس أو خالفه؛ لأنه قول المعصوم، الذي جعل الله تعالى قوله حجة على الخلق أجمعين، وأمرنا باتباعه وطاعته وحذر العقاب في مخالفة أمره، وجعل الفوز في طاعته والضلال في معصيته، وتطرق الخطأ إلى القائس في قياسه أغلب من تطرق الخطأ إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة بعدهم في روايتهم، على أنهم قد خالفوا قياس الأصول بأحاديث ضعيفة فأوجبوا الوضوء بالنبيذ في السفر دون الحضر، ونقضوا الوضوء بالقهقهة في الصلاة دون خارجها".
ودعوى الحنفية نسخ العمل بالقرعة بنسخ الربا دعوى بدون بينة، والحديث نص في محل النزاع، ورد الحديث لمخالفته القياس لم يوافق عليه الحنفية أنفسهم، فلم يبق إلا قبول الحديث، والتسليم لابن أبي شيبة فيما قاله من مخالفة الحنفية للأثر في هذه المسألة.
خامسًا: مَسْأَلَةُ رَدِّ الْوَقْفِ
(1) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أًَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَسَأَلَهُ عَنْهَا فَقَالَ: أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ عِنْدِي أَنْفَسَ مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنَا؟ فَقَالَ: (إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْت بِهَا). أخرجه البخاري (2737)، ومسلم (4311). قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ غَيْرَ أَنَّهُ لا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلا يُوهَبُ وَلا يُورَثُ، فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ، لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ.
(2) حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ أَلَمْ تَرَ أَنَّ حُجْرًا الْمَدَرِي أَخْبَرَنِي: أَنَّ فِي صَدَقَةِ النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- يَأْكُلُ مِنءهَا أَهْلُهَا بِالْمَعْرُوفِ غَيْرِ الْمُنْكَرِ. لم أجد من خرجه.
وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: يَجْوزُ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يَرُدُّوا ذَلِكَ.
***
ذهب أبو حنيفة -رحمه الله تعالى- إلى أن الوقف لا يلزم، ومعناه أن للواقف الرجوع في وقفه لأنه لم يخرج عن ملكيته، فإن مات كان ميراثًا إلا أن يجيز الورثة الوقف؛ لأنه لا حبس عن فرائض الله.
ولا يلزم الوقف عند أبي حنيفة إلا في حالتين:
الحالة الأولى: أن يحكم الحاكم بلزوم الوقف، يقول الكمال بن الهمام في فتح القدير (6/ 200، 204، 208): "وصورة حكم الحاكم الذي به يزول الملك عنده أن يسلمه إلى متول، ثم يُظهر الرجوع فيخاصمه إلى القاضي، فيقضي القاضي بلزومه.
الحالة الثانية: أن يضيف الوقف إلى ما بعد الموت فيلزم بعد موته؛ لأنه يصير بمنزلة الوصية بعد الموت، ونص محمد في السير الكبير أن الوقف إذا أضيف إلى ما بعد الموت يكون باطلًا أيضًا عند أبي حنيفة". وراجع: العناية (6/ 200)، ونصب الراية (4/ 403)، وبدائع الصنائع (6/ 218)، وتبيين الحقائق (3/ 324)، والبحر الرائق (5/ 201).
قال أبو جعفر الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 95): "ذهب قوم إلى أن الرجل إذا أوقف داره على ولده وولد ولده ثم من بعدهم في سبيل الله أن ذلك جائز، وأنها قد خرجت بذلك من ملكه إلى الله عز وجل ولا سبيل له بعد ذلك إلى بيعها واحتجوا في ذلك بهذه الآثار. وممن قال بذلك أبو يوسف ومحمد بن الحسن -رحمة الله عليهما- وهو قول أهل المدينة وأهل البصرة. وخالفهم في ذلك آخرون منهم أبو حنيفة وزُفَرُ بن الهذيل -رحمة الله عليهما- فقالوا: هذا كله ميراث لا يخرج من ملك الذي أوقفه بهذا السبب".
وقد خالف أبو حنيفة في ذلك جماهير العلماء؛ حيث قالوا بلزوم الوقف، واستدلوا على ذلك بحديث عمر وبعمل الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وقد أنكر العلماء على أبي حنيفة قوله هذا، وعذره في ذلك أن الحديث لم يبلغه، حتى إن صاحبيه خالفاه في ذلك وأنكرا عليه قوله. وكان أبو يوسف يقول أولًا بقول أبي حنيفة، ولكنه لما حجَّ مع الرشيد فرأى وقوف الصحابة -رضوان الله عليهم- بالمدينة ونواحيها رجع فأفتى بلزوم الوقف. انظر: المبسوط (12/ 27).
وحكى الطحاوي عن عيسى بن أبان قال: كان أبو يوسف يجيز بيع الوقف، فبلغه حديث عمر فقال: من سمع هذا من ابن عون؟ فحدثه به ابن علية فقال: هذا لا يسع أحدًا خلافه، ولو بلغ أبا حنيفة لقال به. فرجع عن بيع الوقف حتى صار كأنه لا خلاف فيه بين أحد. انظر: فتح الباري (5/ 403).
وقد استبعد محمد بن الحسن قول أبي حنيفة وسماه تَحَكُّمًا على الناس من غير حجة فقال: ما أخذ الناس بقول أبي حنيفة وأصحابه إلا بتركهم التحكم على الناس بغير أثر، ولا قياس لم يقلدوا هذه الأشياء، ولو جاز التقليد كان من مضى من قبل أبي حنيفة؛ مثل الحسن البصري وإبراهيم النخعي رحمهما الله أحرى أن يقلدوا. انظر: المبسوط (12/ 27).
ومع أن هذا الكلام في غاية الإنصاف، فقد تكلم السرخسي بسببه في محمد بن الحسن كلامًا شديدًا تعصبًا لأبي حنيفة فقال: "ولم يُحمد على ما قال، وقيل بسبب ذلك انقطع خاطره فلم يتمكن من تفريغ مسائل الوقف، حتى خاض في الصكوك، واستكثر أصحابه من بعده من تفريغ مسائل الوقف؛ كالخصاف وهلال، ولو كان أبو حنيفة في الأحياء حين قال ما قال لدمر عليه، فإنه كما قال مالك: رأي رجلًا لو قال هذه الأسطوانة من ذهب لدل عليه، ولكن كلُّ مُجْرٍ بِالخَلاءِ يُسَرُّ".
قال الكمال بن الهمام في فتح القدير (6/ 207): "الحق ترجح قول عامة العلماء بلزوم الوقف؛ لأن الأحاديث والآثار متضافرة على ذلك قولًا كما صح من قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يباع ولا يورث) إلى آخره، وتكرر هذا في أحاديث كثيرة، واستمر عمل الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على ذلك، أولها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صدقة أبي بكر وعمر وعثمان وعليٍّ والزبير ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وعائشة وأسماء أختها وأم سلمة وأم حبيبة وصفية بين حُيي وسعد ابن أبي وقاص وخالد بن الوليد وجابر بن عبدالله وعقبة بن عامر وأبي أروى الدوسي وعبدالله بن الزبير، كل هؤلاء من الصحابة، ثم التابعين كلهم بعدهم بروايات، وتوارث الناس أجمعون ذلك، فلا تعارض بمثل الحديث الذي ذكره على أن معنى حديث شريح بيان نسخ ما كان في الجاهلية من الحامي ونحوه. وبالجملة فلا يبعد أن يكون إجماع الصحابة العملي ومن بعدهم متوارثًا على خلاف قوله؛ فلذا ترجح خلافه، وذكر بعض المشايخ أن الفتوى على قولهما".
-أدلة أبي حنيفة:
اجتهد الطحاوي أن يحتج لأبي حنيفة فذكر أدلة؛ منها:
1- أن عمر لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم في أرض خيبر قال له: (حبس أصلها وسبل الثمرة) وذلك يحتمل خروج الأرض من ملكه ويحتمل أن لا تخرج، ولكنها تكون جارية على ما أجراها عليه من ذلك ما تركها ويكون له فسخ ذلك متى شاء، وكذلك ورثته من بعده، وقد روي عن عمر ما يدل على أنه كان له أن يرجع في ذلك، روي عن ابن شهاب أن عمر قال: لولا أني ذكرت صدقتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لرددتها. رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 196). فدل ذلك على أن الذي منع عمر من الرجوع كونه ذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فكره أن يفارقه على أمر ثم يخالفه إلى غيره.
وقد أجاب الحافظ ابن حجر عن ذلك في الفتح (5/ 402) فقال: "ولا حجة فيما ذكره من وجهين: أحدهما: أنه منقطع لأن ابن شهاب لم يدرك عمر. ثانيهما: أنه يحتمل أن يكون عمر أخر وقفيته ولم يقع منه قبل ذلك إلا استشارته في كيفيته، ويحتمل أن عمر كان يرى بصحة الوقف ولزومه إلا أن شرط الواقف الرجوع فله أن يرجع".
2- روى البيهقي في السنن الكبرى (6/ 163) من طريق أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبدالله بن زيد ابن عبدربه الذي أرى النداء أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله حائطي هذا صدقة وهو إلى الله ورسوله. فجاء أبواه فقالا: يا رسول الله كان قوام عيشنا فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهما ثم ماتا فورثهما ابنهما بعد.
قال البيهقي: "هذا مرسل، أبو بكر بن حزم لم يدرك عبدالله بن زيد، وروي من أوجه أخر عن عبدالله بن زيد كلهن مراسيل، والحديث وارد في الصدقة المنقطعة وكأنه تصدق به صدقة تطوع، وجعل مصرفها إلى اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتصدق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبويه".
وقال ابن قدامة: في المغني (5/ 348): "وحديث عبدالله بن زيد إن ثبت، فليس فيه ذكر الوقف، والظاهر أنه جعله صدقة غير موقوف، استناب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى والديه أحق الناس بصرفها إليهما؛ ولهذا لم يردها عليه، إنما دفعها إليهما، ويحتمل أن الحائظ كان لهما، وكان هو يتصرف فيه بحكم النيابة عنهما، فتصرف بهذا التصرف بغير إذنهما فلم ينفذاه، وأتيا النبي صلى الله عليه وسلم فرده إليهما، والقياس على الصدقة لا يصح؛ لأنها تلزم في الحياة بغير حكم حاكم وإنما تفتقر إلى القبض، والوقف لا يفتقر إليه فافترقا".
3- روى الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 96)، والدراقطني في سننه (4/ 68)، والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 162) من طريق عبدالله بن لُهيعة عن أخيه عيسى ابن لهيعة عن عكرمة قال: سمعت ابن عباس يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعد ما أنزلت سورة النساء وفرض فيها الفراض يقول: (لا حبس بعد سورة النساء). وفي رواية قال: (لا حبس عن فرائض الله). قال الدارقطني: عبدالله بن لهيعة وأخوه ضعيفان. وقال البيهقي: إنما يُعرف من قول شُريح القاضي.
4- ما رُوي عن عطاء بن السائب قال: سألت شريحًا عن رجل جعل داره حبسًا على الآخر فالآخر من ولده فقال: إنما أقضي ولست أفتي. قال: فناشدته فقال: لا حبس عن فرائض الله. [شرح معاني الآثار (4/ 96)، السنن الكبرى (6/ 162)].
ورُوي عنه أيضًا قال: جاء محمد بمنع الحبس. [ابن أبي شيبة في مصنفه (4/ 350)، والبيهقي في سننه (6/ 163)]. وشُريح هذا كان قاضي عمر وعثمان وعلي الخلفاء الراشدين المهديين رضوان الله عليهم أجمعين، وهذا لا يسع القضاة جهله، ولا يسع الأمة تقليد من يجهل مثله، ثم لا ينكر عليه منكر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من تابعيهم رحمة الله عليهم. انظر: شرح معاني الآثار (4/ 96).
قال الشافعي: اجتمع أبو يوسف ومالك عند أمير المؤمنين فتكلما في الوقوف وما يحبسه الناس فقال يعقوب: هذا باطل، قال شريح: جاء محمد صلى الله عليه وسلم بإطلاق الحبس. فقال مالك: إنما جاء محمد صلى الله عليه وسلم بإطلاق ما كانوا يحبسونه لآلهتهم من البحيرة والسائبة، فأما الوقوف فهذا وقف عمر بن الخطاب؛ حيث استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (حبس أصلها وسبل ثمرتها). وهذا وقف الزبير. فأعجب الخليفة ذلك منه وبقي يعقوب. [السنن الكبرى للبيهقي (6/ 163)].
وقد أكَّد الشافعي في الأم هذا المعنى الذي ذكره مالك فذكر قوله تعالى: (مَا جَعَلَ اللهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآئِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ) [المائدة: 103] ثم قال: "فهذه الحبس التي كان أهل الجاهلية يحبسونها، فأبطل الله شروطهم فيها، وأبطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبطال الله إياها، ولم يحبس أهل الجاهلية فيما علمته دارًا لا أرضًا تبررًا بحبسها، وإنما حبس أهل الإسلام".
ثم قال: "ولقد حفظنا الصدقات عن عدد كثير من المهاجرين والأنصار، لقد حكى لي عدد كثير من أولادهم وأهليهم أنهم لم يزالوا يلون صدقاتهم حتى ماتوا ينقل ذلك العامة منهم عن العامة لا يختلفون فيه، وإن أكثر ما عندنا بالمدينة ومكة من الصدقات لكما وصفت لم يزل يتصدق بها المسلمون من السلف يلونها حتى ماتوا وأن نقل الحديث فيها كالتكليف".
قال الشافعي: "وحجة الذي أبطل الصدقات الموقوفات أن شريحًا قال: لا حبس عن فرائض الله تعالى، لا حجة فيها عندنا ولا عنده؛ لأنه يقول: قول شريح على الانفراد لا يكون حجة، ولو كان حجة لم يكن في هذا حبس عن فرائض الله عز وجل.
فإن قال: وكيف؟ قيل: إنما أجزنا الصدقات الموقوفات إذا كان المتصدق بها صحيحًا فارغة من المال، فإن كان مريضًا لم نجزها إلا من الثلث إذا مات من مرضه ذلك وليس في واحدة من الحالين حبس عن فرائض الله تعالى، فإن قال قائل: وإذا حبسها صحيحًا ثم مات لم تورث عنه قيل: فهو أخرجها، وهو مالك لجميع ماله يصنع فيه ما يشاء ويجوز له أن يخرجه لأكثر من هذا عندنا وعندك، أرأيت لو وهبها لأجنبي أو باعه إياها فحاباه أيجوز؟ فإن قال: نعم، قيل: فإذا فعل ثم مات أتورث عنه؟ فإن قال: لا، قيل: فهذا فرار من فرائض الله تعالى، فإن قيل: لا، لأنه أعطى وهو يملك وقبل وقوع فرائض الله تعالى، قيل: وهكذا الصدقة تصدق بها صحيحًا قبل وقوع فرائض الله تعالى، وقولك: لا حبس عن فرائض الله تعالى محال؛ لأنه فعله قبل أن تكون فرائض الله في الميراث؛ لأن الفرائض إنما تكون بعد موت المالك وفي المرض".
قال الشافعي: "فعاب هذا القول عليه صاحباه واحتجا عليه بما ذكرنا وأكثر منه قالا: هذا جعل، صدقات المسلمين في القديم والحديث أشهر من أن ينبغي أن يجهلها عالم، وأجاوزا الصدقات المحرمات في الدور والأرضين على ما أجزناها عليه". انظر: الأم (4/ 53). وراجع المنهاج وشروحه: مغني المحتاج (3/ 532)، وتحفة المحتاج (6/ 250)، ونهاية المحتاج (5/ 370). ومختصر خليل وشروحه: منح الجليل (8/ 107)، ومواهب الجليل (6/ 22)، وشرح الخرشي (7/ 79)، والتاج والإكليل (7/ 626).
قال أبو محمد بن حزم في المحلى (8/ 149): "أتى أبو حنيفة بقول خالف فيه كل من تقدم والسنة والمعقول فقال: الحبس جائز في الصحة وفي المرض، إلا أن للمحبس إبطاله متى شاء، وبيعه وارتجاعه بنقض الحبس الذي عقد فيه، ولا يجوز بعد الموت أيضًا وهذا أشهر أقواله. وروي عنه: أنه لا يجوز إلا بعد الموت، ثم اختلفوا عنه أيجوز للورثة إبطاله؟ وهذا هو الأشهر عنه أم لا يجوز؟ وهذا قول يكفي إيراده من فساده؛ لأنه لم تأتِ به سنة، ولا أيده قياس، ولا يعرف عن أحد قبله، وتفريق فاسد فسقط جملة".
وأرى أن سبب مخالفة أبي حنيفة في هذه المسألة أنه تابع شريحًا القاضي، وهذا يصدق ما قاله ابن عبدالبر من أن أغلب ما خالف فيه أبو حنيفة الخبر كان تابعًا فيه لغيره.
وعذر الإمام أبي حنيفة في ذلك عدم بلوغه حديث عمر، ولو بلغه لقال به كما قال ذلك أبو يوسف وهو أعلم بصاحبه، ولا يسعنا إلا متابعة ابن أبي شيبة فيما قاله من مخالفة أبي حنيفة للأثر في هذه المسألة.
سادسًا: مَسْأَلَةُ النَّذْرِ قَبْلَ الإِسْلَامِ
(1) حَدَّثنَا حَفْصٌ عَنْ عُبَيْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ: نََّرْتُ نَذْرًا فِي الجَاهِلِيَّةَ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- بَعْدَمَا أَسْلَمْتُ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَفِيَ بِنَذْرِي. أخرجه البخاري (2042)، ومسلم (4382).
(2) حَدَّثنَا حَفْصٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ فِي رَجُلٍ نَذَرَ فِي الجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَسْلَمَ قَالَ: يَفي بِنَذْرِهِ. راجع: المحلى (6/ 276).
وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: سَقَطَ الْيَمِينُ إِذَا أَسْلَمَ.
***
يُشترط لصحة النذر أن يكون الناذر مسلمًا، فلا يصح النذر من الكافر عند الحنفية والمالكية والصحيح عند الشافعية؛ لأن النذر لا بد وأن يكون قربة، وفعل الكافر لا يوسف بكونه قربة، فمن نذر وهو كافر شيئًا مما يُتقرب به إلى الله ثم أسلم ندب له الوفاء به ولا يجب عليه، ولا يُشترط ذلك عند الحنابلة والظاهرية ووجه عند الشافعية، فيصح نذر الكافر، فإذا أسلم وجب عليه الوفاء به.
قال أبو جعفر الطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 133): "ذهب قوم إلى أن الرجل إذا أوجب على نفسه في حال شركه من اعتكاف أو صدقة أو شيء مما يوجبه المسلمون لله ثم أسلم أن ذلك واجب عليه واحتجوا في ذلك بهذه الآثار، وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: لا يجب عليه من ذلك شيء، واحتجوا في ذلك بما روي عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من نذر أن يطيع الله فلليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه) -أخرجه البخاري (6696)-.
قالوا: فلما كانت النذور إنما تجب إذا كانت مما يتقرب به إلى الله تعالى، ولا تجب إذا كانت معاصي الله، وكان الكافر إذا قال: لله عليَّ صيام. أو قال: لله عليَّ اعتكاف. فهو لو فعل ذلك لم يكن به متقربًا إلى الله، وهو في وقت ما أوجبه إنما قصد به إلى ربه الذي يعبده من دون الله وذلك معصية. فدخل ذلك في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا نذر في معصية).
وقد يجوز أيضًا أن يكون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: (أوفِ بنذرك) ليس من طريق أن ذلك كان واجبًا عليه، ولكن أنه قد كان سمح في حال ما نذره أن يفعله فهو في معصية الله عز وجل، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعله الآن على أنه طاعة لله عز وجل، فكان ما أمره به خلاف ما إذا كان أوجبه هو على نفسه، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى".
وقال الكاساني في بدائع الصنائع (5/ 28): "ومن شرائط الأهلية الإسلام فلا يصح نذر الكافر، حتى لو نذر ثم أسلم لا يلزمه الوفاء به، وهو ظاهر مذهب الشافعي رحمه الله؛ لأن كون المنذور به قربة شرط صحة النذر، وفعل الكافر لا يوصف بكونه قربة".
قال الخرشي في شرح مختصر خليل: "النذر التزام مسلم كُلِّفَ. يعني أنه يشترط في الملتزم للنذر أن يكون مسلمًا مكلفًا فلا يلزم الكافر الوفاء بنذره، ولو أسلم ندب له الوفاء به.
قال ابن رشد: أداء ملتزمه كافرًا بعد إسلامه عندنا ندب". انظر مختصر خليل وشروحه: شرح الخرشي (3/ 91)، التاج والإكليل (4/ 489)، مواهب الجليل (3/ 316)، ومنح الجليل (3/ 97). وراجع: المنتقى شرح الموطأ (3/ 230).
قال النووي في المجموع شرح المهذب (8/ 433): "قال أصحابنا: يصح النذر من كل بالغ عاقل مختار نافذ التصرف فيما نذره... وأما الكافر ففي نذره وجهان: الصحيح: أنه لا ينعقد. والثانء: ينعقد؛ لما روي أن عمر بن الخطاب قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني نذرت أن أعتكف ليلة من الجاهلية فقال صلى الله عليه وسلم: (أوفِ بنذرك). وإذا أسلم إن قلنا نذره منعقد لزمه الوفاء به، وإلا فلا يجب الوفاء به لكن يستحسن، وتأولوا حديث عمر على الاستحباب".
وقال الخطيب الشربيني: "ولا يلزم الكافر وفاء ما نذره في كفره بعد إسلامه، وقوله صلى الله عليه وسلم لعمر في نذر كان نذره في الجاهلية: (أوف بنذرك) محمول على الندب". انظر المنهاج وشروحه: مغني المحتاج (6/ 246)، وتحفة المحتاج (10/ 69)، ونهاية المحتاج (8/ 219).
قال البهوتي في كشاف القناع (6/ 270): "ويصح النذر من كافر ولو بعبادة لحديث عمر: إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أوف بنذرك)".
وقال المرداوي في الإنصاف (11/ 117): "يصح النذر من المسلم مطلقًا بلا نزاع، ويصح من الكافر مطلقًا على الصحيح من المذهب"، وعليه جماهير الأصحاب. وراجع: الفروع (6/ 395)، والمغني (9/ 385).
قال ابن حزم في المحلى بالآثار (6/ 275): "ومن نذر في حالة الكفر طاعة لله عز وجل ثم أسلم لزمه الوفاء به".
يتضح مما سبق أن الخلاف في المسألة ينبني على تأويل الأمر الوارد في حديث عمر، فحمله الحنابلة والظاهرية على حقيقته في الوجوب، وصرفه الحنفية والمالكية والشافعية من الوجوب إلى الندب لقرينة النذر حالة الكفر، وعليه فليس في ذلك مخالفة للحديث كم زعم ابن أبي شيبة.
سابعًا: مَسْأَلَةُ شُهُودِ الرِّضَاعِ
(1) حَدَّثنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَن عُمَرَ بنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: حَدَّثنَا عُقْبَةُ بْنُ الحَارِثِ قَالَ: تَزَوَّجْتُ ابْنَةَ أَبِي إِهَابٍ التَّمِيمِيِّ، فَلَمَّا كَانَتْ صَبِيحَةُ مِلْكِهَا جَاءَتْ مَوْلاةٌ لأَهْلِ مَكَّةَ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا. فَرَكِبَ عُقْبَةُ إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- بِالْمَدِينَةِ فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ وَقَالَ: سَأَلْتُ أَهْلَ الْجَارِيَةِ فَأَنْكَرُوا. فَقَالَ: (وَكِيفَ وَقَدْ قِيلَ). فَفَارَقَهَا وَنَكَحَتْ غَيْرَهُ. أخرجه البخاري (2659، 2660) ولفظه: عن عقبة ابن الحارث: أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب قال: فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني، قال: فتنحيت فذكرت ذلك له قال: (وكيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما). فنهاه عنها. وفي رواية: وكيف وقد قيل، دعها عنك).
(2) حَدَّثنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِي عًَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- مَا يَجُوزُ فِي الرَّضَاعَةِ مِنَ الشُّهُودِ. قَالَ: (رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ). أخرجه أحمد في مسنده (2/ 109)، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 201) وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير، وفيه محمد بن عبدالرحمن بن البيلماني وهو ضعيف.
وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: لا يَجُوزُ إلا أَكْثَرُ.
***
اختلف الفقهاء في نصاب الشهادة على الرضاع: فذهب الحنفية إلى أنه يثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين، ولا يقبل أقل من ذلك، ولا شهادة للنساء بانفرادهن.
وقال الملكية: يثبت الرضاع بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين، وبشهادة رجل وامرأة أو شهادة امرأتينِ إن فشا ذلك قبل العقد، ولا يقبل شهادة امرأة واحدة ولو فشا ذلك.
وقال الشافعي: يثبت الرضاع بشهادة رجلين، وبرجل وامرأتين، وبأربع نسوة؛ لأنه مما لا يطلع الرجال عليه إلا نادرًا، ولا يثبت بدون أربع نسوة.
وقال الحنابلة: يثبت الرضاع بشهادة المرأة المرضية.
الكلمات المفتاحية :
الفقه الحنفي
هذه التدوينة قابلة للنسخ اذا اعجبتك قم بنسخ الرابط من هذه الروابط الثلاثة والصقه بموقعك
URL: HTML link code: BB (forum) link code:

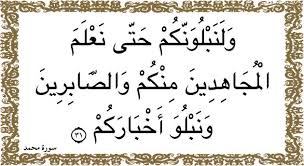

ليست هناك تعليقات: